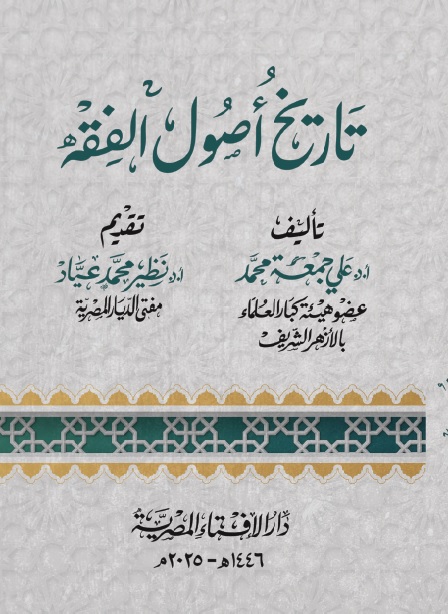الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتَّقينَ، ولا عدوان إلا على الظَّالمينَ، وأصلِّي وأسلِّم على المبعوث رحمةً للعالمينَ سيدنا ومولانا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن سار على دربه، أمَّا بعدُ:
فلقد عُنِيَ علماءُ المسلمينَ بعلم أصول الفقه عنايةً كبرى، وتعددت طرائقهم في التَّصنيف وتنوعت حتى عدَّه الإمامُ الغزاليُّ في مقدمة كتابه: «المُستَصفَى» من أشرف العلوم وأعلاها قدرًا، فهو يقول: «وأشرف العلومِ ما ازدوجَ فيه العقلُ والسَّمعُ، واصطحب فيه الرَّأيُ والشَّرعُ، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيلِ؛ فإنَّه يأخذُ من صفو الشَّرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرُّفٌ بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشَّرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التَّقليد الذي لا يشهد له العقل بالتَّأييد والتَّسديد»[1].
فهذا العلم له منزلته بين العلوم؛ إذ به تتحقق معرفة الأحكام التي أوجبها الله تعالى على عباده؛ لأنَّه العلم الذي تتفرع وتتشابك من شجرته الأحكام دون أن تؤثر هذه الأحكام على قواعده الثَّابتة؛ لذا قيل: «أصولُ الفقهِ هو الذي يَقْضِي ولا يُقْضَى عليه»[2]، ولا غرابةَ في ذلك؛ فهو أساس للأحكام التي تحدِّد مسار الخلق، وترسم طريقهم الموصِّل لبلوغ مصالحهم في المعاش والممات، كما يتأتى من خلاله معرفة مراد الشَّارع والوصول به إلى مقاصد الأحكام، وأهداف الشريعة وغاياتها، وهو ما أشار إليه الإمام الإسنوي في كتابه: «التمهيد» إذ يقول: «إنَّ أصولَ الفقهِ علمٌ عظم نفعه وقدره، وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعيَّة، ومنار الفتاوى الفرعيَّة التي بها صلاح المكلفين معاشًا ومعادًا، ثم إنَّه العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد، كما نص عليه العلماء، ووصفه به الأئمة الفضلاء، وقد أوضحه الإمام الرازي في «المحصول» فقال: يشترط فيه -أي: علم الأصول- أمور؛ وهو أن يعرف من الكِتَابِ والسُّنَّة ما يتعلق بالأحكام، ويعرف المسائل المجمع عليها، والمنسوخ منها، وحال الرُّواة؛ لأنَّ الجهل بشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ، وأن يعرف اللغة إفرادًا وتركيبًا؛ لأنَّ الأدلة من الكِتَاب والسُّنَّة عربيَّة، وشرائط القياس؛ لأنَّ الاجتهاد متوقف عليه، وكيفية النظر وهو ترتيب المقدمات... وأما اللغة فالمعتبر منها معرفة المفردات الواقعة في الكِتَابِ والسُّنَّة، ومعرفة فهم التَّراكيب من الفاعليَّة والمفعوليَّة والإضافة ونحو ذلك دون دقائق العِلْمَينِ -أي: السُّنَّة واللغة- وهذا المقدارُ يسيرٌ جدًّا، ومع ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه، لا حفظه، وترتيب المقدمات أيضا يسيرٌ. وأما شرائط القياس وهو الكلام في شرائط الأصل والفرع، وشرائط العلة وأقسامها ومبطلاتها، وتقديم بعضها على بعض عند التَّعارض، فهو بابٌ واسعٌ تتفاوت فيه العلماء تفاوتًا كثيرًا، ومنه يحصل الاختلاف غالبًا مع كونه بعض أصول الفقه، فثبت بذلك ما قاله الإمام أَنَّ الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه»[3]، وهو عين ما حققه الإمام الإسنوي إذ يقول: «إنَّ الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه»[4].
وهو ما ذكره الإمام ابن السبكي في كتابه: «الإبهاج شرح المنهاج»؛ حيث قال ما نصه: «إنَّ علمَ أصولِ الفقه -وهو من أعظم العلوم- ثلاثة أصناف: عقلية محضة؛ كالحساب والهندسة والنجوم والطب، ولغوية؛ كعلم اللغة والنحو والتصريف والعروض والقوافي والبيان، وشرعية؛ وهي علوم القرآن والسنة وتوابعهما.
ولا ريب في أنَّ الشريعة أشرف الأصناف الثَّلاثة في الوسائل والمقاصد، وأشرف العلوم الشَّرعية بعد الاعتقاد الصحيح، وأنفعها معرفة الأحكام التي تجب للمعبود على العابد، ومعرفة ذلك بالتَّقليد ونقل الفروع المجردة تستفرغ جمام الذِّهن، ولا ينشرح الصدر له؛ لعدم أخذه بالدَّليل، وأين سامع الخبر من المشاهد، وأين أجر من يأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو سُنَّة مِن الذي يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله بأن ذلك دينه، تالله إن أجر هذا لزائد، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد ولا يكمل فيه إلا الواحد بعد الواحد، وكل العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصل الفقه، وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد، وسبح في بحره ودرى من الإله، وبات يعل به وطرفه ساهد»[5].
وما زال العلماء إلى يومنا هذا مشتغلين بهذا العلم، بين مصنف فيه وشارح له، من أجل تيسيره وتسهيله، وتأكيدًا على أهميته، ودوره الريادي في استقامة الفكر، وترسيخ منهجية التفكير السليم، في الاجتهاد والفتوى، ومجابهة الانحراف فيهما، وتحقيق التوازن بين الثوابت والمتغيرات، وكيفية التعامل مع المستجدات، ومواجهة التحديات المعاصرة، والمساهمة في بناء القوانين، وتعزيز الوعي التشريعي لدى المسلمين.
وفي العصر الحديث نجد جمعًا كبيرًا من العلماء عُنُوا بهذا الفن، وفصَّلوا القول في أهميته ومنزلته، وتاريخ تدوينه، وأشهر علمائه، واستمداده، وعلاقته بالعلوم والفنون الأخرى، بجانب تعرضهم لمباحثه وموضوعاته، وانطلاقًا من هذه الحيثيات وغيرها مما يجسد أهمية هذا العلم تحرص دار الإفتاء المصرية على أن يكون لها دور رائد في تعزيز الوعي لدى شباب الأمة عامة، وطلاب العلم الشرعي بخاصة، عن طريق طباعة ونشر الكتب ذات الطابع المتميز، للعلماء والمفكرين المبرزين في تخصص علم أصول الفقه، وفي تخصصات شتى، وقد وقع اختيارنا هذه المرة على كتاب «تاريخ أصول الفقه» لفضيلة أستاذنا الدكتور/ علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.
وقد بدأ فضيلته الكتاب بمقدمة تضمنت إشارة لافتة عن بداية تدريس تاريخ هذا العلم في جامعة الأزهر، ثم أعقبه بتمهيد تناول فيه أولًا : جانبًا عن تاريخ التشريع الإسلامي وأهم المؤلفات فيه، وعن منهج المصنفين وتقسيمهم له إلى ستة أدوار، إلا أنه رأى أن هذه الأدوار يمكن تقسيمها إلى أربعة فقط: عصر الصحابة والتابعين، ثم عصر المجتهدين، ثم عصر المقلدين، ثم العصر الحديث، وقد تكلم فضيلته عن طبيعة كل دور من هذه الأدوار، وما حدث فيه من عوامل نهوض بالفقه الإسلامي وأصوله ومن أسباب ضعف وتدهور، ثم تناول فيه ثانيًا: أهم المصنفات في تاريخ علم أصول الفقه.
ثم انتقل إلى الباب الأول: وفيه الكلام عن المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه: فتكلم عن اسمه، وموضوعه، وفائدته، واستمداده، ونشأته، وفضله، وحكمه، ومسائله، وحدِّه.
ثم انتقل إلى الباب الثاني بعنوان: «نظريات أصول الفقه: عرض جديد»، وبدأه بالإشارة إلى أن فكرة النظرية تعدُّ أبرز المداخل المنهجية في عرض العلوم الحديثة، والتي تعني تلخيص المسائل في مقولة جامعة معبرة عن القضية الأم وتدور حولها المسائل الفرعية لهذه القضية، وبخصوص علم أصول الفقه فهو يرى أن النظريات الضابطة والحاكمة لهذا العلم، والتي تسيطر على العقل الأصولي تتمثل في مجموعة من النظريات وهي: نظرية الحجية، ونظرية الثبوت، ونظرية الدلالة، ونظرية القطعية والظنية، ونظرية الإلحاق، ونظرية الاستدلال، ونظرية الإفتاء، ويمكن إضافة نظرية الحكم أيضًا، وقد أفاض فضيلته في شرح هذه النظريات بطريقة مبدعة، لافتة للنظر.
ثم انتقل فضيلته إلى الباب الثالث بعنوان: «عيون المصادر والمراجع الأصولية» تناول فيه مصادر أصول الفقه عند المذاهب الأربعة، وعند الإمامية، والزيدية، والإباضية، والظاهرية، وختم بمجموعة من المراجع الأصولية الحديثة والمعاصرة.
ثم انتقل إلى الباب الرابع بعنوان: «تراجم أئمة المذاهب الفقهية وتاريخ كل مذهب» وفيه ترجم للإمام الشافعي I، وأعلام المذهب وطبقاتهم، ومصطلحاتهم، وأسس المذهب الشافعي، كما ترجم للإمام أبي حنيفة I، وأعلام المذهب الحنفي وطبقاتهم، ومصطلحاتهم، كما ترجم للإمام مالك I، وأعلام مذهبه، ومصطلحاتهم، كما ترجم للإمام أحمد بن حنبل I وبيَّن أصول مذهبه، ورواته، وأشهر المجتهدين في المذهب.
وقد تخلل الكلام عن كل مذهب وتاريخه مسائل وقضايا لا غنى لطالب العلم عن معرفتها، والإحاطة بها.
وأخيرًا أشير إلى أن فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور علي جمعة هو أحد العلماء المعاصرين المبرزين الذين أثْرَوْا هذا العلم بشروحه المنيعة وتصانيفه البديعة، وهو صاحب فكر متجدد، وطرح متميز، فلا تخلو كتاباته من إضافات نافعة، يتبصر بها المبتدي، ويتنبه بها المنتهي.
ونظرًا لما اشتمل عليه كتابه «تاريخ أصول الفقه» من الفوائد، والدقائق، والحقائق والفرائد التي يعز وجودها مجتمعة في غير هذا الكتاب فقد حرصت دار الإفتاء المصرية على طباعته ونشره للإفادة منه. فنسأل الله العون والتوفيق كما نسأله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدَّم للإسلام والمسلمينَ، وجعل ذلك في ميزان حسناته.
والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أ.د/ نظير محمد عياد
مفتي جمهورية مصر العربية
رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
[1] المستصفى للإمام الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، صـ4، دار الكتب العلمية، ط:1، 1413هـ =1993م.
[2] البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 1/14، دار الكتبي، ط:1، 1414هـ = 1994م.
[3] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الإسنوي، صـ44: 45، تحقيق: د.محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: 1، 1400هـ، وينظر: المحصول للرازي، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، 6/ 21 وما بعدها، مؤسسة الرسالة، ط:3، 1418هـ =1997م.
[4] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الإسنوي، صـ45.
[5] الإبهاج شرح المنهاج، 1/5-6، دار الكتب العلمية -بيروت، 1416هـ= 1995م.
تصفح الكتاب
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa