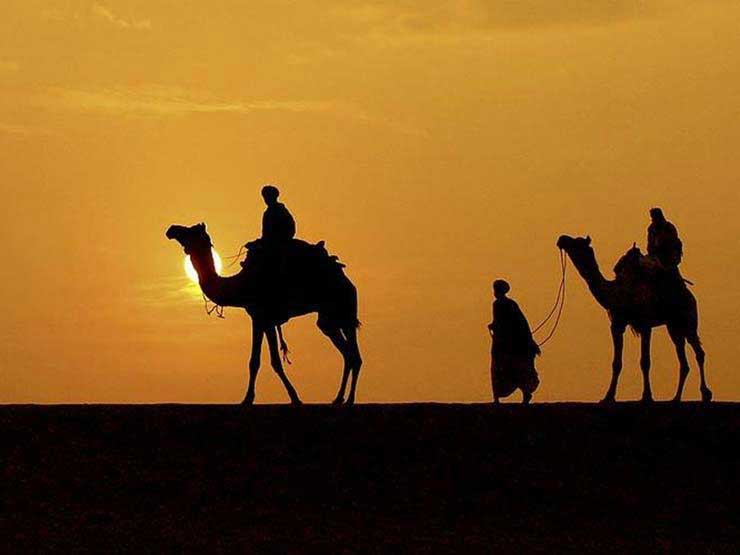مضت الأيام وأقبل موسم الحجِّ عام 621م، وفيه وفد اثنا عشر رجلًا من أهل يثرب، فأزالت أخبارهم السَّارَّة كلَّ هموم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما لاقاهم في المكان المُتفق عليه.
وحينما التقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوفد المدينة، حدَّثوه بأنَّ أهل بلده ينتظرونه ليلتفُّوا حوله ويعتنقوا رسالته حتى يمكنهم أن ينتصروا على اليهود ويتخلَّصُوا مما يحيط بهم من الخلاف والشِّقَاقِ.
وفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء الوفد، فلقد زاد عدد المسلمين إلى اثني عشر رجلًا، ومن ورائهم أهل يثرب، مستعدِّينَ لِقبولِ الدَّعوةِ الإسلاميَّةِ وحماية صاحبها، وفي هذه المقابلة تمت بيعة العقبة الأولى.
وقد تحدَّث عن هذه البيعة عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألَّا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: «فَمَن وَفَّىَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ». وفي لفظٍ: «فَلَهُ الجَنَّة»، «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِي الْدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وِإِنْ شَاءَ غَفَرَ» رواه البخاري في "صحيحه".
فبايعناه على ذلك.
وتُسمى هذه البيعة في التَّارِيخ: بيعةَ النِّساء؛ لأنَّها تُوافِق الشروط التي ورد ذكرها في سورة الممتحنة خاصة ببيعة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: 12].
وتعرف أيضًا: ببيعة العقبة، نسبة إلى المكان الذي عقدت عنده.
وبعد أن تمت هذه البيعة واستعدَّ القوم للرحيل والعودة إلى يثرب، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو فتىً مِن بني عبد الدار، اشتهر بشدة الإخلاص للإسلام، ولقي من خلاف أهله أذىً كبيرًا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين، فكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ والقارئ، ويحدثنا الإمام ابن إسحاق أنه كان يصلي بهم، وذلك أَنَّ الأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَؤُمَّهُ بَعْضٌ، فَجَمَّعَ بِهِمْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الإسلام. وهذا يعطينا فكرة عن مقدار الخلاف بين أهل يثرب، وأنهم كانوا في حاجة إلى مدد خارجي يجتمعون عليه، وهذا ما يسَّرَ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مهمته في المدينة.
وفي المدينة أثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه جديرٌ باختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيام بهذه المهمة الخطيرة، فعلى نجاحها أو فشلها يتوقف مصير الإسلام في يثرب التي تموج بالخلافات وتضطرم فيها العصبية، فكان الداعي اللبق الفطن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويأخذ الأمر بالأناة والصبر والرفق، وكان فتىً اجتمعت فيه خصال قومه الحميدة؛ وأهمها: الحلم الذي سادت به قريش العرب.
وبمثل هذه الأناة والصبر والموعظة الحسنة استطاع مصعب بن عمير رضي الله عنه أن ينشر الإسلام في يثرب، وأن يكتسب إلى جانبه أكبر زعيمين في قبيلة الأوس، وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما اللذان كان لإسلامهما أثر كبير في دخول بطون بِرُمَّتِهَا في حظيرة الإسلام، كما كانا بعد ذلك من أشد أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخلاصًا وتفانيًا في نصرة الإسلام.
وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه قد نزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه يؤمّهم، ويعلمهم القرآن والإِسلام، فأسلم على يديه بَشَرٌ كثير، منهم: أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وأسلم بإِسلامهما يومئذٍ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء، إِلَّا الأُصَيرِمُ، وهو عمرو بن ثابت بن أُقَيش رضي الله عنه، فإِنه تأخر إِسلامه إِلى يوم أُحُدٍ، فأسلم يومئذٍ، وقاتل فقُتِلَ قبل أن يسجد لله سجدة، فأُخْبِرَ عنه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «عَمِلَ قَلِيلًا، وَأُجِرَ كًثيرًا» رواه البخاري في "صحيحه" وأحمد في "مسنده".
لقد كانت بركة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه على أهل المدينة عظيمة، فاستطاعا أن يُدخِلا خَلْقًا كثيرًا في الإِسلام، بل استطاعا أن يؤثرا في ساداتهم ورؤوسهم، فلم يتخلف من قومهم أحدٌ، مما يدل على عمق تأثير التربية النبوية فيهما وشدة إخلاصهما للدين الحق الذي هو الإسلام.
ولقد كان للتعاليم الإسلامية التي شرحها لهم مصعب أثر عظيم في إقبال الناس على الدخول في الدين الإسلامي، لأنهم لم يروا فيه عنتًا أو مشقة، وإنما وجدوا يسرًا ونصائح يصلح بها حالهم ويستقيم أمرهم في الدنيا والآخرة، مع ما كان لهم من استعداد وترقب لرسول تحدثت به اليهود وأخبرت عنه الكتب السماوية، ولذلك زاد عدد الداخلين في الإسلام بيثرب زيادة واضحة، وأسلم على يد مصعب رضي الله عنه عدد كبير حتى لم تبق دار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادئ النفس، ولا تبدو عليه آثار التحمس للدعوة في الفترة التي كان الإسلام يتغلغل فيها في المدينة، وظنَّت قريش أن هدوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا أمارة من أمارات الانصراف عن الدعوة، بعد أن لقي من قريش وثقيف أنواع العذاب، ولذلك رأت أن تخفف من اضطهادها له.
ولكن الحقيقة هي أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم حوَّلَ اهتمامه من قريش في مكة إلى أهل يثرب الذين كانوا دعاة صادقين وأنصارًا متحمسين؛ لأن نفوسهم كانت متلهفة إلى دين يوحِّد كلمتهم ويجمع صفوفهم، ويطهر نفوسهم من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف، فجاءت تعاليمه على يد أولئك الذين أسلموا وكأنها الدواء الشافي لأمراضهم وعللهم.
﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً﴾ [آل عمران: 103].
وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفكر في مصعب رضي الله عنه أثناء غيبته ويفكر في أهل المدينة، ويدعو لمصعب بالتوفيق، ولأهل المدينة بالخير والهداية.
وقد أخذ يتحرى أخباره، وما لاقاه من الأوس والخزرج، هل لبُّوا النِّداء؟ وهل أجابوا داعي الله؟
وهل تكون يثرب مشرِق النُّور الإلهي وينبوع الخير الأبدي؟
وظل هكذا، حتى عاد مصعب رضي الله عنه إلى مكة في موسم الحج بعد إقامةٍ دامت هناك حوالي عام تقريبًا، وقصَّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر المسلمين بالمدينة وأنهم في ازدياد وقوة، وأنهم بعد أيام سيجيئون في موسم الحج أكثر عددًا وأعظم إيمانًا بالله ورسوله.
المصادر
- "سيرة ابن إسحاق".
- "عيون الأثر".
- "القول المبين في سيرة سيد المرسلين" لمحمد الطيب النجار.
- "مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" لأحمد إبراهيم الشريف.
- "الجامع الصحيح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه" للإمام البخاري.
- "المسند" للإمام أحمد بن حنبل.
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa